مساء من الحب والتمرد لمحمود عبدالعزيز
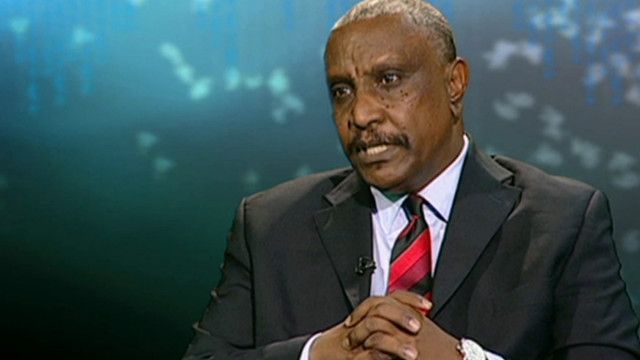
مارس – أبريل 2013
(1)
حينما غيب الموت بعض الموتى الذين هم في الأصل أصدقائي. صدمت والتجأت إلى حائط النعي. أكتب العبارات الموجزة، ولسوء حظي أن قائمتهم أضحت تطول، وفجعت على نحو أخص بالرحيل المبكر لمحمد الحسن سالم حميد، ومتوكل مصطفى، وطارق فريجون، وفي خطوة عجلى مضى محمود عبدالعزيز، وكنت ولا زلت أود أن أكتب عنهم جميعاً يشجعني أصدقائي وأقربائي الذين طالما تمر منعرجات أحاديثنا عن الحياة بظلال أصدقائي الراحلين الوارفة. لم أقل شيئاً بعد. عن العم ميلاد حنا وهو الذاهب (نحو غد أكثر إشراقاً) عن ماكير، دينق ملوي (الطائرة المقاتلة The jet fighter ) أحمد عبد المكرم، عبدالحميد عباس، وعنديفيد دوال، والسفير مجوك أيوم، وقد أضحت الأحزان عابرة للحدود، تمتد على طول تضاريس واقعنا السياسي.
رحل أناس لطالما عرفتهم واستمتعت بصحبتهم ولا أزال، ونحن في عالمين من الحضور والغياب، ولأن بعض الغائبين حضور، فقد قررت أن أحتفي بكل هؤلاء في مقالات تمجد حضورهم. لا تكتفي بنعي الغياب.
وفيما يخص محمود عبدالعزيز على وجه الخصوص. تلقيت رسائل عديدة أخص من بينها رسالة في شبكة التواصل الإجتماعي من عزيزنا محمد الحسن المهدي (محمد فول) طلب مني أن أكتب عن محمود عبدالعزيز، وهأنذا أفعل في مساء من الحب والتمرد لمحمود عبدالعزيز.
في بداية الأربعينيات أعدم النازيون غابريال بيري الذي يطلق عليه رفاقه (بيري العظيم) وهو أحد قادة اليسار الفرنسي. ولد في عام 1902 وأعدم في عام 1941. ومنذ حوالي ثلاثين عاماً قرأت عن غابريال بيري. احتفظت ذاكرتي بعبارة شامخة نسبت إليه حينما سأله في المحكمة الإيجازية الجنرال النازي : “هل لديك كلمة أخيرة؟” والمحكمة تمضي بسرعة البرق، والحكم معلوم، فقال : “لو قدر لأمي أن تلدني من جديد لاخترت الطريقة ذاتها التي سوف توصلني إلى حبل مشنقتك”. ومنذ أن قرأت هذه العبارة وحتى اليوم تسري قشعريرة في الجسم والعقل عندما ندنو من تلك العبارات. خلد بول إيلوار ولويس أراغون، غابريال بيري في قصائد مجيدة، وقال ألبير كامو الذي شهد واقعة اعدامه أن تلك الواقعة قد أجلت رؤيته وتمرده ضدالألمان النازيين، وغابيريال بيري الصحفي والكاتب ذكر في إحدى ملاحظاته الدقيقة والذكيةوالتي بقيت مع الزمن إنه يشعر بالإعجاب عندما يلتقي بالناس العاديين الذين قاوموا النازية دون إدراك كامل لكنهها ودون أن يزعفهم منهج في تحليل ظاهرة النازية وإنه لطالما احترم بطولة هؤلاء.
في بلادنا قاوم ملايين السودانيين جبروت الإسلام السياسي. في الريف والمدينة. من المهمشين والمثقفين، ومن المثقفين المهمشين، ومن أناس لم تطأ أقدامهم ردهات المدارس، والإعجاب كما عبر غابريال بيري يذهب للذين قاموا ظاهرة الإسلام السياسي وهي شكل من أشكال الفكر الفاشي. الذي يوظف الدين والتناقضات الإثنية لتحقيق أغراض دنيوية سياسية محضة، وهي ظاهرة معقدة وملتبسة، ومتسربلة بالدين، وذات ممسك لزج ومخادع، والغوص في دهاليزها صعب في كثير من الأحيان، ولقد كان محمود عبدالعزيز أحد أبطال مقاومة الإسلام السياسي. شكل حالة فريدة من الإبداع والمقاومة معاً وفعل ذلك بما تيسر له من وعي، وأدوات ابداع، وكون في معاركه المتصلة جيشاً من المحتجين معظمهم من الشباب وبعض مهمشي قاع المدينة، وهؤلاء الشباب الذين قضى مشروع الإسلام السياسي على مستقبله وطموحاتهم في الحياة الكريمة الآمنة، ودفع بهم نحو ساحات الحروب والعطالة بعد التخرج.
نسج محمود خيوط علاقاته معهم عبر الابداع والاحتجاج كمتلازمتين، فلم يكن مبدع دون احتجاج، ولم يكن محتج دون ابداع، وقاوم على نحو فعلي ما سمي بالمشروع الحضاري. كان واجهة من واجهات مقاومة قانون النظام العام الذي طالما ألهب ظهر محمود بالسياط ولم يستثني الشباب نساءً ورجال، وهذه نقطة التقاء مهمة بين محمود وجمهور حزبه.
لمشروع الحضاري صُمم لينال من طريقة حياة ملايين الشباب، ومن بينهم محمود نفسه، فهو لا يحترم حرية الأفراد، ولا سيادة حكم القانون، ويتطفل على الناس في داخل منازلهم، ويقدم السياط قبل القدوة والنموذج والاقناع. سد مشروع الإسلام السياسي أفق الحياة المديدة أمام ملايين الشباب، وكان محمود عبدالعزيز نسيج وحده، وكان أحياناً وحده في مصادمة ذلك المشروع، وأدرك على نحو مبكر أن في الابداع وغضب الشباب مكمن قوته. لم يكن لديه منافيستو، ولكنه استخدم منافيستو الابداع، وأدركت أجهزة الدولة التي تمتلك حاسة شم قوية وإنذار مبكر خطر ظاهرته، وحاصرته منذ البداية، واستطاع فك الحصار بطريقته الخاصة. عبر جمهور من المحتجين الشباب الناقمين على قسوة الحياة وكذب الشعارات.
نصبت تلك الأجهزة الشراك له مراراً، وقد حكى لي عدة وقائع مع أجهزة البوليس. يأخذ بعضها بعفوية، ولكن كان لها رسم وتبدير وساعده بعض الضباط والمنتسبين إلى هذه الأجهزة من الوطنيين، وأحياناً ساعدته طرق أخرى ابتكرها للخروج من تلك المآزق، ويبقى جمهوره الذي أحبه هو العامل الرئيسي في معادلة معاركه المتصلة مع أجهزة النظام.
ومثلما تنقل محمود من مسرح إلى مسرح ومن مناسبة إلى أخرى كمغني. كذلك تنقل بينمخافر الشرطة والأمن ومحاكم النظام العام وشرطته التي اقتحمت منزله مرات عديدة. كان له سجل طويل مع هؤلاء الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف. سوى معروف تثبيت أركان النظام.
الذين اقتربوا من محمود يدركون غضبه وتمرده على نظام الإنقاذ. رغم أن معظم أجهزة الإعلام التي يسيطر عليها النظام وعدد كبير من كتابه والمحللين والنقاد في الصفحات الفنية والبرامج التلفزيونية تغافلوا عن عمد عن هذه الحقيقة الساطعة والتي يمكن دعمها بالحقائق والأدلة والشواهد، وهذا ما نرمي إليه في هذه المقالة للمساهمة في وضع ظاهرة محمود عبدالعزيز في اطاره الصحيح والوقوف ضد محاولات إغتياله مرة أخرى، فإن سجلت الأولى ضد مجهول، فإن محاولات تشويه سيرته وإغتياله معنوياً مع سبق الإصرار والترصد لن تسجل ضد مجهول، وعلى الذين أحبوا محمود ألا يسمحوا بذلك، وألا يتركوا بعض القتلة يذهبون في تشييع جنازة المغني، وأن القتل المعنوي كان دائماً أشد من القتل المادي، لأن البشر عابرون، وهم ضيوف في هذه الحياة، لكن الإنسان يعيش بعد رحيله المادي إلى أطول مدى ممكن لاسيما إذا كان ذلك الإنسان مبدعاً ترك وراءه إبداعه مثل محمود عبدالعزيز، وحاجز الصد الحقيقي الذي حمى محمود حياً وغائباً وجعله أكثر حضوراً من بعض الأحياء هو الحائط الصلب من المعجبين الأوفياء الذين أدركوا جوهر وقيمة تمرده، وابداعه اللذان لا ينفصلان، وهو الذي ميز محمود حاضراً ويميزه مستقبلاً.
الشباب الذي خرج خلف جنازة محمود ذو صلة سابقة وممتدة معه إبداعاً وتمرداً، ولم يكتشف محمود مثل ما اكتشفه البعض عند رحيله، والمكتشفون الجدد عادة ما يلونون الحقائق، مثل الذي يستولي على أرض الغير، فهو بحاجة لتزوير الشهادات والتاريخ، وربما كتب تاريخ جديد مختلفاً كلياً عما كان، وقد فعل كولومبوس ذلك وتحدث عن اكتشاف أمريكا ولكن أمريكا كانت موجودة، ذهب كولومبوس أو لم يذهب، ومعرفة الأوروبيين بالعالم الجديد لا يلغي وجوده السابق.
حينما جابه محمود سياط النظام العام وتعدياته على خصوصيات الناس داخل منازلهم وأحياناً داخل عقولهم. كان ذلك حادثاً ومصاباً مشتركاً مع ملايين المصابين من الشباب، وعلى الرغم من عربدة وبلطجة أجهزة النظام عرف محمود طريقه للشباب وعرف الشباب طريقهم إلى محمود. كانت له أوقات ومراكز ثابتة للإطلال على جمهوره، وإلم يتمكن من الوصول إلى جمهوره فإن الجمهور يصل إليه. حتى في مراكز الشرطة، وقد كون جمهوره روابط في مدن عديدة مثلت فروعاً لحزبه. كان جمهوره على مقدرة للتسامح مع هفواته، وقد ذهبت مع محمود ولبيت دعواته مراراً، ووافيته في مناطق مختلفة من مراكز نشاطه. أشهرها ميدان التنس في الخرطوم، والذي كان يضج بمئات وأحياناً آلاف الشباب حبيس الدموع في المآقي، والباحث عن الحب والفرح.
كان محمود يشبعهم غناءً وتمرداً، وكان نجماً من نجوم المسارح المفتوحة والأندية ودور الرياضة والصالات المغلقة، وأين ما حل كان له جمهوره. حتى في أسوأ لحظات أداءه، وقد أصبح رمزاً وظاهرة وكون حركة أشبه بحركات الاحتجاج الإجتماعي الإبداعي، وهي ظاهرة عالمية ضد أنظمة القهر وفي مساندة القضايا الكبيرة، وحينما تقوم أنظمة القنع بقهر المنظمات السياسية، ودور المجتمع المدني، وتواجه تذمر الملايين، فإن رحم الملايين يولد أشكالاً مختلفة من أشكال المقاومة. كاملة الوعي أو محدودة الوعي، ويتمتع رموزها أحياناً بوعي وبرؤية صافية أو محدودة في رفضها واحتجاجها ضد القمع والقهر، وتنسرب مراكز المقاومة من بين يدي الديكتاتورية الصماء، وحتى الأنظمة الديمقراطية التي تحاول التغطية على الأزمات وتزييف وعي الجماهير بغبار كثيف من أجهزة إعلامها وتحاول تغبيش الحقائق والوعي بالظواهر والأزمات، فإن الناس يجدون من بين المبدعين من يعبر عن أشواقهم واحتجاجاتهم الدفينة غير المعبر عنها بأغنية أو مسرحية أو نص شعري أو فيلم سينمائي أو رواية أو غناء شعبي مجهول النسب، وغيرها من ضروب الإبداع التي تحمل هموم الناس مع اختلاف الأزمنة والأمكنة والشخوص، وإن شخصيات فاعلة في مسرح الحياة والإبداع والتاريخ كانت دائماً حاضرة مثل ظهور (البيتلز) وقائدهم جون لينون، وبوب مارلي، ورود غيريز، وخليل فرح، وقد عبروا بصدق عن أزمنتهم وكانوا ناطقين رسميين باسم تلك الأزمنة، وباسم أجيال كاملة وقضايا كبرى في التاريخ الإنساني، وقد شهدت مؤخراً الفيلم الوثائقي عن بوب مارلي، وفيلم آخر يسمى “شوجر مان – Sugar man” عن رود غيريز، وتضامنه ووقوفه ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، وهو فيلم وثائقي شيق أعاد رود غيريز إلى الحياة مجدداً، مثلما كان دوماً نصيراً للعدالة وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين، وقد استمتعت بالحوارات مع رود غيريز الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تصوير الفيلم، ونتطلع لفيلم وثائقي عن ظاهرة محمود عبدالعزيز وربطها بالمناخ والقضايا التي عبر عنها والتي لا تزال تشغل ذهن ملايين الشباب وهي في وجه من وجوهها توثيق للعلاقة المعقدة بين الشباب والمشروع الحضاري.
كثير من المبدعين وبعضهم قامات سامقة في بلادنا التزموا بمشاريع ثورية للتغيير على نحو واضح، ولم يتركوا وقتاً للاستنتاج حول رؤيتهم أو التزامهم لاسيما موقفهم السياسي، وعلى الرغم من أن محمود عبدالعزيز ربطته علاقات بعدد من المثقفين الملتزمين على نحو قاطع في فترات مختلفة من حياته، ولكن مسيرته تتيح الفرصة لكثير من الاستنتاجات حول مواقفه السياسية. خصوصاً إذا ما تم مقارنة ذلك بمواقف مبدعين شديدي الإفصاح عن مواقفهم السياسية مثل الأعزاء الكبار محمد وردي ومصطفى سيد أحمد، ومع ذلك، فأن واحداً من قضايا هذه المقالة أن محمود عبدالعزيز كان واضح الإنحياز، وأنه كان ناطقاً رسمياً لإحتجاجات الشباب في ظل نظام الإنقاذ، ومن العصي توزيع دمه بين كل القبائل، فقد انتمى لقبيلة من الإبداع والإحتجاج دون غيرها، وهو عنوان ورمز من رموز احتجاجات الشباب، وإن إبداعه يندرج في الصف الطويل للمبدعين الذين وقفوا مع قضايا الناس، ومحاولات رسم صورته كمغنٍ لا قضية له طلقة لن تصيب هدفها. مثلما هي المحاولات العديدة لرسم صورة لمحمد علي كلاي كملاكم أسطوري وقاطرة بشرية دون التوقف عن موقفه الشهير من حرب فيتنام ومن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أو حتى حينما غير ديانته واسمه كنوع من أنواع الاحتجاج والتدين معاً، ومثلما هو الحديث عن محمد وردي كفرعون وإمبراطور وإطلاق ألقاب مضللة تحاول تغييب موقفه الإجتماعي السياسي كداعية كبير من دعاة التغيير، وهذا لا يعني حصر وعزل إبداعه وتجييره بلون سياسي محدد وتغييب أبعاد أخرى من إبداعه، بل بالأحرى إبراز كل جوانب الظاهرة الإبداعية، وفي حالة محمود فإن إغفال علاقة إبداعه بالاحتجاج وأنه رمز لجيل كامل من الشباب، دفع ثمن مواقفه عداً ونقداً فإن ذلك بمثابة محاولة للإغتيال المعنوي لظاهرته ورمزيتها وما احتشدت به من ابداع واحتجاج وتمرد لا إنفصام للعلاقات الداخلية بين كل هذه المكونات، وحسن فعل الشباب الذي تمسك بالتعبير عن حبه لمحمود بعد رحيله وأعطى صفعة ماهرة لكل محاولات تشويه صورته سوى الذين تباكوا عليه كمبدع لا كمحتج وكإنسان لا قضية له، أو الذين ذهبوا للتقليل من قيمته بإنه إنسان لا قيم ولا قيمة له. بل هو صنو للضياع كما عبر أساطين المكر وأدعياء التدين من شيوخ وصحفيي الإنقاذ.
تمتع محمود بعلاقات مع مثقفين ملتزمين بقضايا التغيير، صعوداً وهبوطاً، وقد تزامنت فترات صعوده مع أسوأ فترات صعود مشروع الإسلام السياسي الذي عمل على تجفيف كل منابع الفكر المستنير، ومع ذلك تتجلى عظمة محمود، أنه استطاع في ذلك الوقت أن يسجل فصلاً ملحمي ذو ذوق خاص ارتبط بالجمهور صعوداً وهبوطاً، ولم يبخل عليه ذلك الجمهور حياً وميتاً بالحب والمؤازرة، والناس الذين ساروا خلف جثمانه يدركون قد جسد بعض أحلامهم في الاحتجاج، والخروج عن المألوف والسائد، شكلاً ومضموناً، وإنه كان يغرد خارج سرب الإسلام السياسي وسيطرته على مفاصل ومسامات الحياة. أعجب الجمهور بتحدي المغني للنظام العام، بمعناه الضيق والواسع، وكسب المغني وخسر النظام العام.
واللافت لأي مهتم، وحتى وإن لم يكن متخصصاً في قضايا الإبداع من أمثالنا. لابد أن يتوقف عند الحقيقة الباهرة للمغني، الذي لم يكن المبدع الوحيد في زمانه. نافسه وتواجد معه كثر، ومع ذلك لم يلتفت الجمهور للآخرين مثلما فعل معه!
ولقد صعد معه الجمهور ناصية الطريق. لماذا حدث ذلك ؟ لابد من أسباب وإجابة، وهذه واحدة من أهداف هذه المقالة التي تخرج في صف محمود، مثلما خرج آلاف الشباب في تشييعه، والمقالة هذه مهداة للشباب الذين خرجوا خلف جثمان المغني. هل أحب الشباب المغني بسبب تفرده في الغناء والتطريب وحده ؟ هل تم ذلك لجماليات الغناء والإبداع وحدها ؟ لا أعتقد ذلك، ومن مسافة قريبة أتاحت لي التعرف على شخصية محمود. إنساناً ومبدعاً، وسوف أاتي إلى ذلك في سياق هذه المقالة. يمكن القول وباطمئنان وارتياح أن محمود قد مزج بين جماليات الغنآء وجماليات الاحتجاج، ولم ينافسه الكثير من أبناء جيله في ذلك، وهنا يكمن الفارق الذي ميز حب الجمهور لمحمود دون غيره من مجايليه حتى أصبح له مريدين شكلوا لوحته البهية التي فاجئت البعض ممن اكتفوا بملامسة سطح ظاهرة إبداعه. واكتفوا بقشور مسلكه الشخصي والانطباعات السيارة التي كان بعضها من صنع أجهزة النظام التي عملت على تكوين صورة قيمية وأخلاقية لتهيل التراب عليه حياً، ولكن المغني استطاع الافلات من شباك صياديه مرات عديدة، باتباعه قانوناً وحيداً وأبدياً خالداً، بأن اتجه إلى الجمهور مبدعاً ومحتجاً، وكان الجمهور كريماً معه لاسيما في الأوقات التي كان النظام العام وسياطه تلهب ظهر المغني والجمهور فاتحد المغني مع جمهوره، وكان له موعد مع الشباب الباحثين عن رمز، والفصل كان محلاً وصيف، وكانت الأعوام أعوام للرمادة. أطول من أعوام الرمادة على زمن الفاروق، ولا فاروق في أعوام رمادتنا هذه، والناس تبحث عن رجاء وأمل، وتقدمت خطو محمود مع خطو الشباب المطمئن، وعرف المغني طريقه نحو الحياة.
أتى محمود بعد أن انقشع غياب مغنٍ آخر تمتع واستأثر باهتمام كبير عند الشباب، هو الأستاذ مصطفى سيد أحمد، وتزامنت تواريخ رحيلهم معاً، وقد جسدا أحلام الشباب معاً، مع الفارق والإختلاف. أتى محمود في سنوات سبقت وتزامن بعضها مع مصطفى سيد أحمد في الساحة الفنية.
حينما تعالت سياط النظام العام من ثناياها خرج محمود عبدالعزيز، ونهض إبداعاً واحتجاجاً، وتحكي بعض الصور لحظات باقية لثبات المغني وهو يتلقى السياط في حفل ليس (للبطان). بل في مخفر من مخافر النظام العام، وتوحد المغني وجمهوره في مواجهة النظام العام ومحافله، والإنقاذ تعرف خطر الشباب، وحاولت منذ البداية أن يقوم مشروعها على إذلال وكسر روح التحدي عند الشباب، وكان قانون النظام العام واحداً من أدواتها. مثلما هي مطاردة الشباب وحلق رؤوسهم في الساحات العامة، في الأسابيع الماضية، والغرض ليس هو قطع الشعر المنسدل، بل اقتطاع مشاعر التحدي، بل ربما لوضع الشباب في صدام مع القوات المسلحة التي لا يخولها أي نص من الدستور والقانون ومهامها في أن تصبح أكبر (حلاق في البلد) بعد ما حدث لها ما حدث في الحروب الداخلية لنظام الإنقاذ.
ولأن المغني ابن من أبناء الحارات والأحياء الشعبية، فقد التقط رائحة الاحتجاج، وسار مع الشباب وكون حزباً عريضاً من المحتجين. أحس المغني بأشواق الشباب في الحياة الكريمة، ورأى الحزن والدموع في المأقي وتسرب أحلام الشباب، فاختار أن يكون صوتاً من القادم، ولا قادم إلا مع الشباب، وإذا كسب المغني الرهان وتجرعت منابر النظام العام وأدعياءه (زفرات حري) ولم يتمكنوا من فك شفرة المغني والجماهير التي خرجت خلف جنازته وضربوا أخماس في أسداس في الحديث عن فساد أخلاق الشباب، ولم يتحدثوا عن فساد أخلاق شيوخ المشروع الحضاري، وما حز في أنفسهم ليس فساد أخلاق الشباب بل احتجاج الشباب الذي أصهروه عند موت المغني، والحديث عن الأخلاق مطية قديمة عند هؤلاء الشيوخ، وقد كانوا يخفون هلعهم بدس رخيص وهم قد أبصروا بأم أعينهم أن حزب المغني أكبر من حزب النظام العام، وكان ذلك في حده رسالة خطيرة بتوقيع جمهور عريض. إن الذي رحل في ذاك اليوم لم يكن المغني، بل هو حزب النظام العام، والمشروع الحضاري، الذي لا صلة له بالحضارة إلا بالسطو على اسمها، وعلى بلاد بكاملها، وللناس خيارات، والله يختار ويصطفي من يشاء، وقد اختار المغني وحبب فيه خلقه، وبالضد تتبين الأشياء. أن الله لا يحب قانون النظام العام. الذي لا يتوانى عن انتهاك حرمات الناس حتى داخل منازلهم. كما أنه لا يحب النفاق، وقد أحب صدق المغني، وأحب احتجاجات الشباب التي تدعو للعدالة والحق واحترام آدمية الإنسان، والأصل في الإنسان الحرية وفي الدين كذلك، وما زال صوت الفاروق المجلجل عبر الحقب(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) في أوجز وأجزل عبارة لميثاق عالمي لحقوق الإنسان.
السيتينيات بعنفوانها وشبابها، واحتجاجاتها، وأحلامها الكبيرة في عالم جديد. موجاتها العاتية تحمل جون لينون وفرقة البيتلز كواحدة من … نواصل
(2)
السيتينيات بعنفوانها وشبابها، واحتجاجاتها، وأحلامها الكبيرة في عالم جديد وموجاتها العاتية تحمل جون لينون وفرقة البيتلز كواحدة من عناوينها الرئيسية. أتى البيتلز من ليفربول، من أصولها العمالية التي تضع بصماتها على توجهاتهم لاحقاً. يهبطون وقائدهم جون لينون على مدرجات غضب شباب السيتينيات، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدى جون لينون وبول ماكارتي ورينجو ستار وجورج هاريسون والآخرين يتحدون النظام الرسمي ويغنون ضد حرب فيتنام (أعطي السلام فرصة/Give peace a chance) يتغنون للنساء-المرأة زنجي العالم الحديث- وترتفع راياتهم إلى عنان السماء، حتى إن جون لينون قال مزهواً : “إن البيتلز اليوم أشهر من المسيح”، ودفع ثمناً لهذه العبارة الزائدة، فالعبارات التي تجاوز بعض الحدود وتخدش جدار آخرين مكلفة اليوم كما في السيتينات، ومن أحشاء وضوضاء السيتينيات، من احتجاجاتها ومن معطف أحلامها خرج جون لينون يتحدى ماهو سائد وأضاف إليه بيتاً من الشعر بزواجه من يابانية – أوكا أونو- خارقاً حاجز صوت الإثنيات السميك في السيتينيات. وفي خاتمة المطاف دفع جون لينون حياته ثمناً وبقى نجماً مضيئاً وهادياً على مر الأزمنة، فالإنسان يعيش أكثر بعد رحلته القصيرة على وجه البسيطة. ومؤخراً احتفلنا في مواقع التواصل الإجتماعي مع جموع غفيرة بعيد الميلاد الثمانين لأوكا أونو التي لا زالت ترفع راية جون لينون مع تغير المناخ ولكن جون لينون لا يزال بهي الطلعة والطلة كما كان.
ما خرج البيتلز من أحشاء السيتينيات كذلك خرج محمود عبدالعزيز من أحشاء النظام العام، من سياطه وعلى غضب الشباب من النظام العام استند محمود بقوة إلى حائط جمهوره الصلب، وهذا من الممكن أن يكون أحد التواريخ التي تؤرخ لميلاد المغني المحتج في التسعينيات العجاف في بلادنا وجبروت سنوات قهرها، وإن الحياة جميلة يا صاحبي.
والذين يتساءلون من أين جاء محمود المغني، فالإجابة عند سياط النظام العام والذين فاجئهم جمهوره عند محطات المغادرة والوداع، لم يمتد بصرهم إلى التسعينيات، والجمهور الذي خرج لوداع المغني يعلم أن فرعون النظام العام لا يرتدي ملابس ولا صلة له بالصحابة، بل بأسواق المواسير. وقد التقاهم المغني في محطاته الأولى وفي نقاط البوليس ومعسكرات الخدمة الإلزامية، ففي عام واحد وبعد اتفاقية السلام في 2008 تم فتح 48,000 بلاغ ضد النساء في ولاية الخرطوم وحدها، بموجب قانون النظام العام، ويمكن القياس على ذلك لمعرفة ما جرى في السنوات السابقة. والمغني المبدع والمحتج كون حزبه من الجمهور الذي قتلت قوانين القمع أحلامه، وكان ذلك الجمهور حاضراً معه في كل المنعطفات، وما حدث في مدينة ود مدني قبل عدة أسابيع من رحيل المغني لم يكن حدثاً معزولاً ووحيداً، فقد وقف الجمهور مع المغني في كل المحطات وكان المغني يوزع السخرية والإبداع، والمال لم يكن همه، وكان له رصيد كبير من المسامحة إذا ما تخلف عن موعد مضروب مع الجمهور، ومحمود كان عادلاً في ذلك فهو لا يغيب عن جمهوره فحسب، بل عن مواعيد شديدة الخصوصية وعزيزة على نفسه أحياناً، ففي إحدى المرات طلب مني المجيء وموافاته في إحدى الأندية ببري، وأكد على حضوري عدة مرات، وأتيت وتغيب محمود، إن قلبه واسع، ومليء بحب الناس، ومن حب الناس يأخذ الأعذار عند الغياب.
البداية كانت في القاهرة منذ أكثر من عقد من الزمان، اتصل بي صديق ونقل لي دعوة عشاء من محمود عبدالعزيز وكان حينها مغنياً ذائع الصيت، وتوقفت عند الدعوة، فهو سيعود مجدداً إلى الخرطوم ويطلب لقاء أناس في قائمة الخصومة مع حكام الخرطوم، وفي الزمان والمكان المحددين ذهب وإذ بي أمام عالم من الإبداع والفوضى، ومع متمرد كامل الدسم. رحب بي ترحيباً حاراً، وتحدث عن إعجابه بالحركة الشعبية وبقادتها ولاسيما جون قرنق دي مبيور، وكان ودوداً وكريماً، وسعدت بالتعرف عليه، وببعض الغناء، وامتدت معرفتي به لسنوات عن قرب. تعرفت على إنسانيته، واستمتعت إليه متحدثاً ومغنياً، والتقيته في أوقات عادية، وفي أخرى كان في عين العاصفة والمتاعب مع رجال الشرطة والأمن، وهو يحدثني في أوقات متأخرة من الليل طالباً مني المجيء إلى إحدى حفلاته أو متاعبه أو إلى منزله في بحري، وتعرفت على والدته العظيمة، وزرت أسرته في مناسبات مختلفة والتقيته وهو قد أنفق الأموال على من حوله دون منّ وأذى، وقد مشى فقيراً مثل عامة الناس، وقد لاحقه البعض ونصبت له بعض الأجهزة الفخاخ في مناسبات مختلفة.
كان محمود نظاماً من الفوضى، وفوضى في انتظام، وكان الطريق إليه مزدحماً بالمريدين والمعجبين، وكان حزبه مكوناً من ذهب الشباب الخالص وحماسهم، وكانت أمسياته وردية مزدانة بالمئات والآلاف من الشباب دوماً على استعداد لحضور عروضه والارتياح من ضنك الحياة، وكانوا يجلون شيخهم في التمرد مقابلاً لشيوخ النظام، ومحمود عامر بالجمال وبفوضى الجمال معاً، وهو شحنة من الغضب المضيء، وشعلة من الإبداع، والكرم واللامبالاة، لاسيما حينما يأتي الأمر إلى الانتظام في تناول الطعام وأخذ قسط من الراحة، ودقة المواعيد.
كان يؤدي كل شيء على طريقته الخاصة مثل أغنية فرانك سيناترا الشهيرة (I do it my own way)، فهو يقوم بالأشياء على طريقته ومزاجه الخاصين. وقد رحل مبكراً وترك إرثاً عظيماً للمبدعين الشباب لمن أراد منهم الذهاب في طريق الناس العاديين، طريق الفقراء والمعذبين، وأحلام الشباب، وهو طريق للخلود.
تحدثت مع محمود ومع أكثر من صديق حول أثر تجربته في أوساط الشباب، وضربنا أكثر من موعد معاً مع ساحر الإبداع الكبير محمد وردي، ولكن زحمة الحياة حالت دون ذلك. وكنت أتردد كثيراً على نشاطات مركز صديقنا طارق الأمين في بحري، وأحياناً اذهب إلى منزل محمود عبدالعزيز، وأذكر جيداً في إحدى الأمسيات استمتعت بالذهاب إليه سيراً على الأقدام، وكان منزله دوماً نزلاً من نزل الضيوف، من أصدقاءه والعاملين معه وأبناء السبيل، وكان محمود واسطة العقد في تواضعه بين الضيوف.
حينما خلا الزمن للنظام العام وتحكم في حياة الشباب وحظرت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وجد الشباب الناقم في محمود رمزاً بيده أداة من الإبداع، وغاضباً ومحتجاً مثل الشباب تماماً، ونسج المغني الصلات إبداعاً واحتجاجاً وشعرت أعين النظام بالخطرو ترصدته وتعقبته، وقد سمعت وشهدت أكثر من حدث وصل حد إشهار السلاح ضده. وقد كانوا يدركون خطر جماعات الشباب التي تقف خلفه، وكان أيضاً يدرك أهمية جمهوره، وتعاملوا معه في كثير من الأحيان بشيء من الابتزاز والالتفاف محاولين كسر إرداته. وكانوا يتعمدون وضعه في مواقف صعبة وحرجة ثم يطلبون الثمن لإخراجه منها، بعد أن دبروها بعناية وقاومهم طويلاً، وبمختلف الأساليب التي ارتد بعضها إليهم. كانوا أجهزة منظمة، وكان أحياناً وحيداً و كانوا يمنون أنفسهم على نحو مريض لإجباره على الظهور ليشدو بإبداعه في منابرهم لكسر خاطر جمهوره، واستخدموا في ذلك كل الوسائل وأجهزة الإعلام التي كان بعضها أقرب إلى النصب منه إلى الإعلام، وكانوا يتوسلونه بطرق مختلفة للوصول إلى أهدافهم من مدح النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم إلى مدح الإنقاذ.
الشباب الذين انتصروا لمحمود ضد الإنقاذ كانوا يدركون بحسهم ومن واقع تجاربهم نفسها ألاعيب النظام، ولهم تجارب مع مداورات وابتزاز شرطة النظام العام التي تعمل على طريقة(حاميها حراميها) فهي تلقي القبض على الفتيات بدعاوى الحياء والأخلاق واللبس والسلوك الفاضح، وتراود ضحاياها من الفتيات أنفسهن، وحينما ذكرت ذلك في ندوة في جبل أولية بعد شكاوي عديدة وصلت إلينا في الهيئة البرلمانية ومن عضوات في الحركة الشعبية وشباب عاديين كثر، هددت تلك الشرطة بفتح بلاغ ضدي أو أن أعتذر عن حديثي، وحينما رفضت دخلت في مسرحية طويلة لرفع الحصانة عني وأكاذيب عن وساطات للتخلي عن بلاغها المفتوح، وقد أتى إلى مكتبي عشرات المواطنين المستعدين للشهادة ضد شرطة النظام العام، واستمعت إلى العديدين من الضحايا مما جعلني أدرك إن الشباب الأذكياء الذين رفضوا مشروع الإنقاذ منذ بدايته دون دخول أي مدرسة سياسية قد تعلموا الكثير من تلك التجارب، ومن عجز الشعارات ومفارقاتها لواقع الحال ومن دخولهم إلى معسكرات الدفاع الشعبي و(دفارات) الخدمة الإلزامية، ومرورهم ببند العطالة، وتحطم أحلامهم في جبهات القتال لأكثر من عقدين كان ذلك كافياً لإعطائهم الجرعة السياسية التي يحتاجونها والمناعة حتى لا يصدقوا روايات الإنقاذ حول حالنا العام وحول المغني، وليس من رأى كمن سمع.
خلال حكم الفريق عبود وفي إحدى القطارات في ولايات الشمال، حكى لي المبدع العظيم محمد وردي أنه التقى بالمناضل العمالي فارع القامة والقيمة قاسم أمين، أحد المؤسسين للحركة النقابية السودانية، وأحد قادة النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني في الجبهة المعادية للاستعمار، وكان وقتها وردي قد تغنى مرحباً بنظام عبود في 17 نوفمبر الشعب طرد جلاده فقال له قاسم أمين ضاحكاً : “إذا الشعب طرد جلاده في 17 نوفمبر ما فائدة البنعمل فيهو ؟!” ودخل معه في حوار طويل حول طبيعة نظام عبود، وقد ذكر وردي أن هذه المناقشة التي لا تنسى هي واحدة من ضمن أحداث وتجارب لاحقة فتحت عينيه وعقله لإلتزام جانب الشعب حتى نهايات رحلته العظيمة التي التقى بها قامات سامقة من المثقفين منهم صلاح أحمد إبراهيم، محمد المكي إبراهيم، وتاج السر الحسن، والفيتوري وعمر الطيب الدوش ومحجوب شريف وعلى عبدالقيوم، ومبارك بشير، والطاهر ابراهيم والحلنقي، إلى آخر القائمة العظيمة -والدجى يشرب من ضوء النجيمات البعيدة-.
ولو قدر لمحمود أن يمضي أكثر عمقاً في وضوح رسالته من محطة الاحتجاج إلى رسم خارطة المجتمع الجديد لغير على نحو أكثر مضاءة موازنات عديدة في عالم الإبداع والاحتجاج، ومع ذلك، فإن قيمة محمود تظل أنه قد عبر بصدق عن طموحات الشباب وأصبح رمزاً من رموز الإبداع والإحتجاج الجماعي وكون حزباً من الناقمين والرافضين والمهمشين وضحايا القهر، وقد استطاع أن يوظف رصيده بشكل لم يستطعه أي من المبدعين الشباب الآخرين وأخذ مكانه عن جدارة ودفع ثمن عناده، وحينما رحل، كان رحيله لحظة كاشفة وإعلان صريح لرفض مجموعات وقطاعات مهمة من الشباب لمشروع الإسلام السياسي، ولم تسعف النظام خبراته في التحكم في الأحياء وجنازات قادة المجتمع التي تأتي من الخارج من إخفاء عورة النظام، ولم تستطع أجهزة الإعلام تقديم تفسير صادق لظاهرة محمود والتعاطف والإهتمام الشعبي الكاسح، والعدوى التي انتقلت من الشباب لسائر المجتمع، وإذا كان الشباب السوداني اليوم يمثل أكثر من 43 % من السكان، وإن أكثر من 70 % من خريجي الجامعات عاطلون عن العمل، وأن أكثر من 70 % من الميزانية السنوية تستخدم في تمويل الحروب العبثية، فبإمكاننا أن ندرك أن قضية الشباب السوداني واهتماماته ومزاجه والتوجهات والتيارات التي ستقود مسيرته الآن وفي المستقبل تشكل مستقبل السودان كله، وقد أبرز رحيل محمود جانباً من جوانب هذه الصورة، وهي رسالة للجميع حاكمين ومعارضين، على ضفتي النهر. إن قضية الشباب كانت الأكثر وضوحاً وهو ما أزعج النظام وعلينا التأمل عميقاً في هذه القضية لأنها ستلازمنا لوقت ليس بقليل.
الخرطوم على وشك استقبال دكتور جون قرنق دي مبيور بعد أكثر من عشرين عاماً من الغياب والحضور معاً، والثبات والنزال ورفع رايات المحرومين من إنسان ولد في ريف مدينة بور، في منطقة وانقلي، وحلم بوحدة السودان وانتقل تأثيره إلى مركز السلطة والحكم في الخرطوم، وفي ترتيبات الاستقبال كان محمود عبدالعزيز فاعلاً وحاضراً ….. نواصل
(3)
6 مايو، 2013
الخرطوم على وشك استقبال دكتور جون قرنق دي مبيور، بعد أكثر من عشرين عاماً من الغياب والحضور معاً، والثبات والنزال ورفع رايات المحرومين من إنسان ولد في ريف مدينة بور في منطقة وانقلي، وحلم بوحدة السودان، وانتقل تأثيره إلى مركز السلطة والحكم في الخرطوم، وهو القادم من الهامش. وفي ترتيبات الاستقبال كان محمود عبدالعزيز فاعلاً وحاضراً، وأوكلت لي مهمة التحضير للاستقبال، وبدأت المهمة على نحو جدي، في وضع الترتيبات في شهري مايو ويونيو، وحتى وصول قرنق مبيور أتيم إلى الخرطوم يوم الجمعة 8 يوليو 2005، حيث كنا نعمل ليل نهار لاكمال الاستعدادات، وأبدا محمود منذ البداية رغبته في المشاركة وشارك في عدة فعاليات واشترى من ماله الخاص ( 2000 تي شيرت – قميص ) مطبوع عليها صورة الدكتور جون قرنق وعلى الجانب الآخر صورة محمود عبدالعزيز وهي مشاركة واضحة وصريحة لا تخطئها العين وخلدت عدسات المصورين تلك اللقطات ومحمود يرتدي نفس القميص في الساحة الخضراء، وقد وزعها على مجموعات الشباب التي دعاها للمشاركة وتابع معي سير التحضير للاستقبال. ولقد كان محمود واثقاً في حديثه معي أن وصول الدكتور جون قرنق سيحدث التغيير المطلوب، وظل يردد عبارة أثيرة له قائلاً : “وجود الدكتور سيقلب الصفحة يا كماندر” وحزن حزناً شديداً على رحيل جون قرنق الذي كان يعتبره بطلاً شخصياً له، وانكسرت إحدى أحلامه بالرحيل المبكر والمفاجئ لقرنق مبيور.
لم يغفر له المؤتمر الوطني وأجهزته التي رصدت كل ذلك، وتوغل أكثر في تحدي المؤتمر الوطني واتخذ موقف أكثر صراحة في الإنحياز السياسي وتحدي السلطات في أهم دوائر اهتماماتها، حينما أعلن موقفاً صريحاً في الوقوف إلى جانب الحركة الشعبية في انتخابات رئاسة الجمهورية إلى جانب الأستاذ محمد وردي في 2010، وحضر تدشين الحملة الإنتخابية في منزل الزعيم علي عبداللطيف في أم درمان، وشارك بعد ذلك في عدة مناشط من ضمنها أن دعاني لحفل أقامه في مدينة ود مدني، وآخر في نادي التنس، وكان موقفاً شديد الإفصاح عن الأرض السياسية التي اختار الوقوف عليها، وقد جر له ذلك الكثير من المتاعب مضافاً إليه سجل طويل عند أجهزة النظام، لاسيما في التسعينيات، وبالإمكان تعداد الكثير من المواقف التي لم يتوانى عن الإعلان عن مواقفه دون مواربة. وبعد بداية الحرب الأخيرة أرسل لي عدة رسائل في عام 2011 عن المعاناة والتربص الذي يشعر به. وإن اجهزة النظام استهدفت قائمة طويلة من المبدعين في مختلف ضروب الإبداع من مسرح وغناء وفكر، وإنتهت بإغلاق مراكز الدراسات، وتعرض المبدعين لمختلف صنوف التضييق والمطاردة، وصمد الكثير منهم مثل حالة النقش على الصخرة الباهرة التي واظب عليها بجسارة الفنان الكبير أبوعركي البخيت، ويحظي بحب الناس وتعاطفهم ولاسيما الشباب.
أحب محمود الجنوب وذهب إليه في زيارات، وكان له رصيد وسط شباب الجنوب ولاحظت مؤخراً أن عدد من الشباب السودانيين الجنوبيين يضعون صورته على حساباتهم في شبكة التواصل الإجتماعي. واقترب على نحو ما من قضايا القوميات والتنوع، ولامس ذلك من خلال بعض إبداعاته، وكان يعبر بشكل مقتضب في لقاءاتنا عن حبه للجنوب وضمت دائرته وفرقته شباب من مختلف أنحاء السودان، ومنزله كذلك. لقد احتفى بالتنوع على طريقته الخاصة، وكان شخصاً ذو ذكاء اجتماعي، وحس مطبوع بالسخرية، ويختزل المفارقات في عبارات موجزة، وسريعة مضحكة وموجعة، ولا يخوض في الجدل السياسي المطول، ويكتفي بتلغرافات سياسية توجز وجهة نظره، وفي أحيان قليلة كان يوجه لي أسئلة مباشرة عن الوضع السياسي، وكان يود أن يطمئن أن التغيير واقع لا محالة وأننا نسير في الاتجاه الصحيح. وهو شخص يتميز بالكاريزما التي تمكنه من اتخاذ المواقف والشجاعة والوضوح في معظم الأوقات رغم تعقيدات الوضع السياسي والمصاعب التي أحاطت بحياته وإذا ضاعت بوصلته لبعض الوقت ولم يتمكن من حل شفرة الوضع السياسي سرعان ما يستعيد بوصلته نحو الإتجاه الصحيح. والفترة الأخيرة من حياته والتي انتهت بأحداث مدني ودخوله المستشفى والمأساة التي أحاطت بكل ذلك كانت إحدى فتراته الصعبة، وكان قادراً أن يعود إلى الطريق التي تضعه في صدارة حب الناس، ولكنه قد رحل. وعندما رحل عبرت قطاعات كبيرة عن حزنها الشديد على رحيله وتبلورت صورة أسطورية له في المخيلة الشعبية.
محمود ظاهرة سوف تتكرر، فالمواقف الوطنية والاحتجاج والإبداع عميقة الجذور في التراب السوداني منذ أركماني الذي دعا إلى فصل الدين عن الدولة إلى عبدالمنعم عبد الحي وإسماعيل عبد المعين إلى أخر القائمة الطويلة والمجيدة، ففي إحدى إنتباهاته النافذة والرصينة ذكر عبدالمنعم عبدالحي من ضمن أحاديث ذكرياته أنه عندما أراد أن يوصف أمدرمان لم يجد فيها جانب أجمل وأخلد من الجانب الوطني، وذكر أنها صورة مصغرة للسودان وأنها تمثل الشعب السوداني كله من الشمال والجنوب وكتب : أنا أمدرمان تأمل في نجوعي .. أنا السودان تمثل في ربوعي، أنا ابن الشمال سكنته قلبي ..على ابن الجنوب ضميت ضلوعي. وحينما يشق الفجر دياجير الظلام سنكتشف جميعاً أن أكبر ثرواتنا الوطنية هي من صنع المبدعين وأن الغناء في كثير من الأوقات قد حمل سحر وجداننا المشترك معانٍ وموسيقى، وعبدالمنعم عبدالحي وهو سوداني شمالي وسوداني جنوبي ينحدر من القبائل النيلية من قبيلة الدينكا، وهو كما عبر هو نفسه سليل طلبة الكلية الحربية الواقفين بالرماح ضد الإنجليز، وهو الذي حارب في مصر وفي فلسطين، وانتمى إلى كل هؤلاء وأولئك. وهو من الذين بحثوا بحثاً مضنياً عن ما هو مشترك، وهم كثر. ولا تخطئ العين اسماعيل عبد المعين الذي أدرك سحر التنوع الثقافي في جماليات الموسيقى والألحان المختلفة والمتنوعة عند مختلف شعوب السودان، وبحث عنها وطوّر وأضاف واجاد، ودفع بموسيقانا إلى الأمام مستلهماً تنوع الإيقاعات السودانية في مختلف أنحاء السودان التي قام اسماعيل عبد المعين بزيارتها.
إن وحدتنا الحقيقية ستكون يوماً من صنع ثقافتنا وتاريخنا المشترك قبل مشاريع الحكومات التي لم ترحب بالتنوع والتعدد، ومحمود عبدالعزيز حينما اقترب من الحركة الشعبية فإنه لم يقترب من السياسة فحسب، بل اقترب من ذاك التنوع والتعدد الثقافي الذي تحفل به بلادنا امتداداً لمواقف عديدة أبدى فيها سخطه وتبرمه من حالتنا الراهنة. وقد كانت له نفس معذبة وشفافة وعامرة بحب الناس، ولا شك أنه كان رافضاً لما هو قائم وأعطى إشارات بينة في رغبته في مشروع بديل نقيض لما هو قائم، يحترم خصوصيات الأفراد ويقيم العدالة. ووضوح محمود عبد العزيز في رفض ما هو قائم هو الذي أعطاه زخم الشباب.
في سجون مصر وفي حادث صدفي محض، الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم (الفاجومي) الذي كان زاجلاً يكرس شعره لمباريات كرة القدم، ودخل السجن في شأن آخر وخرج بشأن أكثر خطورة حينما التقى بالمثقفيين اليساريين المصريين في السجن (وياما في السجن مظاليم)، وانحاز من يومها للمظلومين وما يزال. وقد أمضيت أمسية جميلة حينما قمت بزيارة أحمد فؤاد نجم مع أخي وصديقي كمال الوسيلة، وصديقنا العزيز حمدي رزق، وحكى لنا عن تجاربه وحياته، وعن الشيخ إمام، وعلي اللبان، والغورية، وتعرفنا على ابنته نوارة نجم التي أصبحت لاحقاً واحدة من رموز الثورة المصرية. وقرأنا عليه ما حفظناه من قصيدة مبدعنا الكبير محجوب شريف : “طير يا حمام، ودي السلام للشيخ إمام وأحمد فؤاد، هينين محبة وحزمتين شتل إحترام، والمستحيل يخلو الفؤاد من حلمه بالوطن الجميل، والنهر ما بيستأذن الصخرة المرور، والنجمة ما بتستأذن الطلعة الظلام”، وقد تنبأ محجوب شريف بالثورة المصرية حينما قال : “يا مصري يا حلو يا بشوش، ما تيأسوش، الأصل إنتو حيمسح المطرالرتوش، مين البنى الهرم، الملوك ؟ طز في الملوك من ألف عام، طز في التواريخ المسجلة في الرخام?. إلخ”، وللحياة أحكام، وليست النهاية والبداية واحدة، وهكذا فإن الحياة تختار للناس بعض المهام، مثلما أعطت مهمة عظيمة لأحمد فؤاد نجم فإنها أيضاً كانت جميلة الاختيار حينما صعد نجم محمود عبدالعزيز من بين عشرات الفنانين الشباب المبدعين، واختار طريق الإنحياز لقضايا الشباب، وكان صوتاً عالياً من أصواتهم، وقد أدى مهمته ويستحق أن ترفع له القبعات وأن نرتدي السواكني إمعاناً عن الإعلان في حبنا لأهل شرق السودان.
إن الارتباك والالتباس في تقييم ظاهرة محمود عبدالعزيز في بعض جوانبه متعمد من أجهزة إعلام النظام التي حاولت أن تطوي صفحته بعبارات الثناء وبعض الأدعية وهم مجبرون على ذلك للشعبية الكبيرة التي حظي بها، وقد حاولوا عرض قصته كقصة من قصص التعاطف الإنساني حتى يلتبس أمر المغني على الناس وحتى لا يتم تقييم ظاهرته على نحو صحيح وحتى لا تطرح أسئلة على شاكلة : من أين، وكيف، ولماذا ظهر محمود عبدالعزيز، ولماذا أحبه الناس وما هي القضايا التي عبر عنها وما هو المناخ الذي شكل ظاهرته. وقد استخدموا في ذلك بعض معارفه حتى يقومون بإغلاق ملف سيرته على نحو لا يثير قلق النظام، وحتى لا يولد محمود آخر في دنيا الإبداع، ولكن هذه الملفات من الصعب إغلاقها، وإلا تمكنت السلطات البريطانية وبعض كرام المواطنين من إغلاق ملف على عبداللطيف، وإلا لما جاءت إمرأة من اليابان البعيد (الدكتورة يوشيكو كوريتا ) لترسم صورة أخرى ومغايرة للزعيم علي عبد اللطيف.
إنني أثق بأن الشباب والمثقفين والمبدعين سيرسمون الصورة الحقيقية لمحمود عبدالعزيز ويضعونها في إطارها الصحيح بكل جوانبها. وأخيراً أود أن أقول :
لمحمود مساء من الحب والتمرد
إليك وأنت تعود من أوجاع الطريق
طول المسافات
سحر الغياب
حب الشباب
فوضى المكان
افتضاح النفاق
يُتم البلاد
ووهج الغناء
مساء من النسيان
كي تعود لناصية الغناء
لا تبالي الموت
عند مولدك يكفيك أمك وحدها
وعند الموت يكفيك التمرد
وأنت النهوض قد بدا لنا
واستعصم بالحب عنا
مع مودتي الدائمة .
ياسر عرمان



