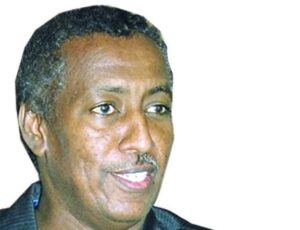بَسَالة المَوقِف (تعليق عابر على سقوط الفاشر)

“بالرغم من توامض البروق وتواليها، بالرغم من تفجر الرعود وهزيمها لوقت، إلا إنها لم تمطر بعد.” (محمد سليمان الفكي الشاذلي، رواية صقر الجديان، ص. 279)
تحرير (وليس سقوط) الفاشر يعني بالضرورة تخلص الريف الدارفوري كافة من وصاية العصابة الإنقاذية، بيد أن الدلالة الكبرى تتمثل في تحرر هذه الشعوب من هيمنة النخب النيلية التي تسللت إلى موقع النفوذ الاقتصادي والسياسي – على الأقل في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة – من خلال امتهانها لدور النِّخاسة في تجارة الرق التي سلكت من بين طرق أخرى درب الأربعين لقرون تأصلت فيها تراتيبية عرقية ظنها البعض حكمة إلاهية وليست جريمة ضد الإنسانية أطّرت لثقافة إجتماعيّة ما زال السودان يعاني من تداعياتها، ألا وهي ثقافة الفرخ والفرخة (العبد والخادم).
لا ننسى تعاون هذه النخب النيلية في فترات تاريخية متفاوتة مع المستعمر الذي ظلت تزوده بمعلومات عن تحركات القبائل ذات الميول الأنصارية أو التيجانية. هل هذا يعني أن كل جلابي جاسوس؟ لا لكنه “مشروع متعاون” لزم دعمه في تلك الأونة من قبل السلطات المصرفية والشرطية والإدارية كي يتهيأ يوماً لأداء دور اقتصادي أو سياسي محدد.
بتحرير الفاشر يكون الثوار قد اقتلعوا آخر شِعبة من “زريبة عمسيب” تمهيداً لتفكيك إرث العبودية، ذاك الإرث الذي أثقل كاهل الأمة السودانية وأقعد بها عن سلوك درب التنمية والتحضر. زريبة عمسيب هي زريبة اتخذها التاجر عمسيب (شايقي الأصل) حظيرة يجمع فيها العبيد في نيالا، حاضرة جنوب دارفور اليوم، استعدادا لترحيلهم إلى مصر في غابر الزمان ومنها إلى تركيا وأوروبا.
لقد اخترت هذه الزريبة من باب التمثيل وليست الحصر إذ إنّ هناك زرائب انتشرت في مدن أخرى مثل ديم زبير في بحر الغزال لكنني آليت النظر إلى هذه بالذات لأبين للكل عقدة الناشط الاسفيري عبدالرحمن عمسيب، صنيعة الاستخبارات العسكرية، ونظرائه من الجهلاء أصحاب “دعوة النهر والبحر” الذين اختاروا أن يهربوا إلى الأمام بحثاً عن ميكانيزمات تعويضية للهزائم العسكرية التي مُنيت بها مجموعتهم القبلية وتفادياً لمواجهة الواقع الثقافي والسياسي المعقد والمتشابك الذي قد ينجم عن ذلك فاختاروا أن يكونوا عبيداً للمصريين فضلاً عن معايشة المهانة التي قد تتبدى في التساوي مع المواطنين الآخرين!
حتى وإن انصهر الجلابة الدارفوريون في مجتمعات دارفور وحُرِم بعض السلاطين الدارفوريين من ريعها فإن ثقافة الرق لم تزل راسخة في المخيلة السودانية لم تزعزعها غير قناعات الدول الأوروبية خاصة بريطانيا التي منعت الرق وشدّدت على منعه دون أن تسعى حينها لمعالجة الآثار النفسية السالبة لهذه الجريمة التاريخية. قد لا يصدق المرء أن تجار الرقيق البريطانيين طالبوا بتعويضات مالية لأنفسهم ولم يعبأوا بالأضرار الاقتصادية التي لحقت بهؤلاء البشر جراء استبقائهم في العبودية لقرون. وقد تمّت تلبية طلباتهم دون أدنى حرج.
بالمثل فإن هناك من يزعم هذه الأيام أن دارفور باتت تشكل عبئا على التصاريف السياسية والمصاريف المالية ولذا فقد وجب التخلص منها والاكتفاء “بمثلث حمدي” الذي هو مثلث المستعمر البريطاني، علماً بأن الغرب الجغرافي والاجتماعي ظل يرفد الشمال بكل أنواع الخيرات المادية والهبات المعنوية ولم يشرع للمطالبة بحقه بالقوة حتى ضاقت به الحيل واستنفد كافة السبل.
هذه هي الظروف الثقافية والاجتماعية التي تشكّل فيها الوجدان السوداني والتي هيأت الإنقاذ (بعد العشرية الأولى التي حصل فيها الفرز العرقي) ومن قبلها الحقبة الاستعمارية لترفيع بعض الضباط إثنياً وترقيتهم بناءً على ولاءاتهم القبلية، فكانت كل اللجان الأمنية فترة الإبادة الجماعية تتكون دون استثناء من النخب النيلية، القادمة تحديداً من الشمالية ونهر النيل (راجع “البروتوكولات السرية” لجهاز الأمن الوطني). بيد أن الإنقاذ لم تجرؤ على المحاولة لاستمالة الجلابة الدارفوريين والذين لا يقلون صلابة وصمودا عن أي قبيلة دارفورية بل إن ولاء بعضهم كان أعظم قدراً إذ رفضوا لعب الأدوار القذرة التي لعبها “الفلنقيات” من أبناء دارفور (الفلنقيات: فئة من البشر تعاني من هزيمة معنوية تجعلها دوماً في حالة إحساس بالدونية تجاه الآخرين).
رغم قتامة المشهد فلابد من ذكر الإشراقات التي طبعت مساهمة الجلابة في الحقبة التي تلت نيل السودان لاستقلاله في عام 1956. لقد قدّمت النخب النيلية يومئذٍ متمثلة في قبائل العبابدة والكنوز والمحس والحلفاويين والدناقلة والشوايقة والجعليين والشكرية وأولاد الريف وآخرين من جاليات مشرِقية ومغرِبية مختلفة، في تلكم الفترة بالذات إسهامات رائعة في الإدارة والتعليم والقضاء والشرطة والغابات وكل مناحي الحياة المدنية حتى قدِمت الأنظمة الشمولية وأطاحت بالمعايير الأخلاقية والمهنية مفضلةً الولاء على الكفاءة فانبرى لقيادة المجتمعات أراذل القوم الذين وجدوا في الحكم وسيلة لاضطهاد الآخرين والحط من أقدارهم علّ ذلك يكون شفاءً لأنفسهم السقيمة من داٍء قديم وعِرقٍ سَحيم. لم تستنكف نخب الريف الانتهازية من تصيد الفرص في هذا المناخ المتسخ فأساءت تمثيل مجتمعاتها التي لم تعرف يوماً طأطأة الرأس للدخلاء ولم تعتمد التملق وسيلة لاستجداء الحقوق من السفهاء.
إن الجرائم التي ظلت ترتكبها هذه النخب المركزية هي جرائم منهجية ارتكزت على مبررات واهية كالمؤسسية وفرض سيادة الدولة والحفاظ على هيبتها، لكن الأدهى هو توفر مسوغ أخلاقي تستفزه أو تستحثه بعض الجينات الخَرِبة والتي لا يرى صاحبها عيباً في محاولة الحط من كرامة الآخرين باسم العنصرية. كي يدرأ هذه التهمة اختار المؤتمر الوطني أحمد هارون، المجرم المطلوب للجنائية الدولية (صاحب مقولة “أمسح أكسح، أُكلو ني ما تجيبو حي”)، رئيساً كي توظفه لإكمال جريمة تخريب الوطن التي بدأها بقتل الزرقة في دارفور، فض الاعتصام، وصولا إلى معركة “الكرامة” التي استحالت إلى ساحة “ندامة” سلبت الإنسان السوداني كل دواعي الشرف والسؤدد. يتفانى هذا الكائن اللئيم في الدفاع عن وضعيته ويستميت في إسداء المعروف لسادته خشية المساءلة والوقوف يوماً تحت طائلة القانون وليس اعتقاداً في ورع وتقوى شيوخ الحركة الإسلامية!
ختامًا، تحرير الفاشر ليس مجرد حدث عسكري، بل لحظة رمزية لانهيار إرث طويل من الوصاية المركزية والاستعلاء العرقي. إنه تفكيك لبنية هيمنة تأسست على تجارة الرق وتواطؤ النخب النيلية مع المستعمر، التي أُعيد إنتاجها لاحقاً عبر أنظمة الاستبداد. في هذا الانتصار تتبدى بشائر الانعتاق من ثقافة اجتماعية مشوهة رسّخت دونية الريف وهمّشت إنسانه. ومع أنها لا تُغفل إسهامات بعض النخب في مراحل التأسيس، إلا أن هذه المقالة تدعو إلى تجاوز الولاءات الضيقة، وهدم الزرائب الرمزية، والانتصار لقيم العدالة والمساواة، في معركة لم تعد فقط بالسلاح، بل تعمّقت وترسخت ركائزها بالوعي واليقين ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.