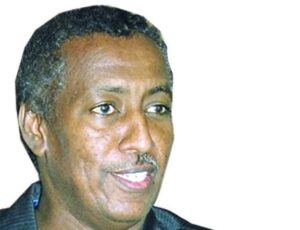السودان أمام مفترق مصيري: لا دولة بجيش مختطف ولا سلام بوجود قوات موازية

ليس صحيحًا – كما حاول الفريق البرهان الإيحاء في خطابه أمام الضباط – أن سؤالاً: “أين هم الإخوان المسلمون؟” هو سؤال بريء أو اكتشاف متأخر. فوجود الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة السودانية العسكرية والمدنية ليس موضوعًا جديدًا أو محل جدل، بل هو حقيقة راسخة يعرفها القادة العسكريون والأمنيون قبل غيرهم.
وإذا كان الفريق البرهان يتساءل: “وين هم الإخوان؟”
فالجواب بسيط: ليس المطلوب التفتيش في الظلام، بل النظر حوله. وجود الإخوان لا يقتصر على الأشخاص، بل على القرارات والسياسات:
اليوم ما زالت كوادر الحركة الإسلامية تقود وتوجه مفاصل الدولة الحساسة:
النائب العام، الذي يفترض أن يكون حارس العدالة وصوت الضحايا، عطل ملفات الفساد وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، ووجّه أجهزة الدولة لإنتاج ملحقات إعلامية تستهدف التشويه والمحاسبة السياسية لمن يطالبون بإيقاف الحرب، محوّلاً النيابة العامة إلى أداة دعائية لتلميع مشروع سياسي بدلاً من تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وزارة المالية التي تديرها شبكة مصالح مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية والعسكرية.
بنك السودان الذي تُستخدم سياساته لحماية اقتصاد الحرب وتمويل شبكات التنظيم.
وزارة الخارجية التي ما تزال تدار وفق أجندة العلاقات القديمة والتمثيل السياسي غير الوطني.
. المنظومة الدفاعية والاقتصاد العسكري المسيطر على 82% من موارد الدولة خارج الميزانية الرسمية
إذن، الحديث عن غياب الإخوان من الجيش والدولة ليس حقيقة، بل مسرحية سياسية هدفها التهرب من المسؤولية ومحاولة غسل اليد من مشروع الحرب والتمكين.
يقف السودان اليوم على عتبة خيارين لا ثالث لهما:
فإما أن تستمر هذه الحرب الغوغائية اللعينة التي يقودها دعاة الموت والخراب والنهب والسلب الباحثون عن مواقع في الدولة فوق جماجم عشرات الآلاف من الضحايا، ويُساق الشعب إلى معاناةٍ يومية تتجسّد في المرض والجوع، وضياع سبل العيش، والنزوح القسري، وتآكل السيادة الوطنية واستقلال القرار، وتتصاعد خطابات الكراهية، ويتفكك النسيج الاجتماعي، وتعلو الولاءات الجهوية والعنصرية، وينحدر الوعي الجمعي والقيم الأخلاقية إلى دركٍ غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث؛ هو طريق الجحيم.
وإما أن يختار السودانيون طريق السلام والعقلانية والمسؤولية الوطنية، قبل أن يبتلع الانهيار ما تبقّى من الدولة والمجتمع، ويضيع ما تبقّى من حلم الوطن الآمن المستقر؛ طريق النعيم.
إن الطريق نحو السلام لا يعني مجرد وقفٍ لإطلاق النار أو هدنة عابرة، بل تحوّلٌ جذري في الوعي والسلوك السياسي، يبدأ بالاعتراف بأن الحرب ليست قدرًا محتومًا، وأن العنف لا يبني دولة، بل يدمّر مؤسساتها، ويقضي على مقومات بقائها.
فاختيار السلام يعني أن يعلو صوت الوطن فوق أصوات البنادق، وأن يتقدّم الضمير الوطني على الولاءات الضيقة. أن يتجاوز السودانيون جراحاتهم وانقساماتهم القبلية والجهوية والعسكرية، ليتوحدوا حول مشروعٍ وطنيٍ مدنيٍ جامع يعيد بناء الدولة على قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية، لا على منطق القوة والغنيمة والإقصاء.
السلام المنشود ليس سلام الصفقات الهشّة ولا التسويات المصلحية، بل سلام الشعب الحقيقي؛ سلامٌ ينبع من القرى ومخيمات النازحين والمنافي، من دموع الأمهات وصبر الثكالى، ومن أحلام الشباب الذين لم يعرفوا في حياتهم سوى الحرب والفقر. إنه سلامٌ محوره الإنسان السوداني كهدف للتنمية وصانعٍ للمستقبل، سلام يبني مؤسسات الدولة لتخدم المواطن لا لتقهره، ويحمي سيادة الوطن لا مصالح قوى النفوذ والهيمنة.
هذا الطريق يتطلّب شجاعةً سياسيةً وأخلاقيةً لوقف نزيف الدم، وإرادةً جماعيةً تتجاوز منطق الانتقام والدمار إلى البناء. ولن يتحقق ذلك إلا عبر حوارٍ وطنيٍ شاملٍ وحقيقي يؤسس لعقدٍ اجتماعيٍ جديد، يعيد الثقة بين الدولة والمواطن، ويضع الإنسان وكرامته في قلب المشروع الوطني، باعتباره أساس النهضة والاستقرار.
لن يتحقق السلام في السودان صدفةً، ولا عبر تسويةٍ مصطنعة تُفرض تحت ضغطٍ خارجي، بل عبر مصارحةٍ ومصالحة سياسية شجاعة تُواجه الأسئلة الجوهرية المتعلقة بمستقبل الدولة بدل الهروب منها.
إن المنعطف الخطير والمأزوم الذي تمر به أمتنا يستوجب نقاشًا صريحًا ومسؤولًا يجيب عن ثلاث أسئلة، في الطريق للسلام المنشود:
هل الجيش الحالي مؤسسة وطنية خالصة؟
رغم تاريخه الطويل منذ تأسيسه في العام 1945 كقوة دفاع السودان، فإن الجيش السوداني خضع منذ انقلاب 1989 لعملية اختطافٍ أيديولوجي هيكلية نفذتها الحركة الإسلامية عبر سياسة التمكين التي أعادت تشكيل بنيته القيادية والتنظيمية والاقتصادية، وحولته شكلاً وموضوعاً من مؤسسةٍ ذات سيادة وتقليد عسكري وارث وطني إلى ذراعٍ سياسية تخدم مشروعًا ضيّقًا، ومن مؤسسةٍ تحمي الدستور إلى أداةٍ أيديولوجية تتخلى عن النظام، وتخدم مشروع النظام كأداة من أدوات قمع الشعب وحماية امتيازات فئة ضيقة، غارقة في السمسرة وساكتة عن تكوين الجيوش الموازية، وفي مثل هذا المناخ، تم استبدال الانضباط العسكري بالولاء السياسي، وجيرة القرارات الأمنية والعسكرية للتمكين السياسي وبناء شبكات اقتصادية قائمة على المحسوبية والنهب.
وعند اندلاع الحرب انطلقت أكبر عملية تجييش للعواطف، وتم استثمارها لإدامة الصراع عبر منظومة محكمة من الخداع والإلهاء والسيطرة النفسية. تُوظّف النخب الأيديولوجية للتحريض العاطفي والخطاب الشعبوي لتعبئة الجماهير خلف سياساتٍ قمعية أو عسكرية، وتحول الخوف والغضب والحنين إلى أدواتٍ فعالة لضمان الولاء والطاعة.
ومع كل الدماء الغزيرة التي سالت وما زالت تسيل، تتكرّس الحرب كأداةٍ للسيطرة والاستثمار والفساد، تدرّ على النخب العسكرية والإسلاموية مكاسب سياسية واقتصادية ضخمة، فيما يدفع الشعب الثمن من دمه وحريته وكرامته ولقمة عيشه. يتحوّل العنف والحرب إلى نظام حكمٍ تغذّيه الدعاية والإعلام والخوف لتستمر دورة الصراع — لا باعتبارها وسيلة لإنقاذ الدولة — بل كآلية لإدامة النفوذ والهيمنة، وإبقاء الشعب في دائرة الطاعة والعجز عن تحقيق السلام أو استعادة القرار الوطني الحر.
إن ما نعيشه من تفككٌ شامل لمؤسسات الدولة، وانهيارٌ متسارع للتماسك الاجتماعي، وتآكلٌ للنسيج الوطني بجميع مكوناته وتوقف عجلة الإنتاج، وتَحوُّل موارد الدولة إلى أدواتٍ للإفقار المنهجي الذي يُعمّق بنية الاستبداد، ويُضيّق آفاق التنمية أمام المواطنين يجعل من الجيش مجرد جهاز يحرس مصالح قلة نافذة على حساب كرامة الشعب ورفاهه وحقه في مستقبلٍ آمن وعادل.
ومن ثمّ، فإن الحديث عن “إصلاح الجيش” لا معنى له ما لم يُحرَّر أولًا من الشبكات المسيطرة داخله. فالإصلاح المطلوب إصلاحٌ سياسي–بنيوي لا فنيّ، يستهدف إعادة بناء العقيدة العسكرية على أساس المواطنة والمهنية والدستور، لا الولاء الحزبي والأدلة. فالتحرير شرط الإصلاح، وتجاهله لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الانقلابات والعنف تحت لافتات جديدة. إنه أمر لا مناص منه.
هل تحقيق السلام لن يتم إلا بهزيمة الدعم السريع؟
صحيح إن وجود قوةٍ مسلّحة تعمل خارج إطار الدولة يهدد احتكارها المشروع لاستخدام القوة، ويضرب في صميم مفهوم السيادة، بل وجود الدولة كسلطة حديثة، ويقوّض مفهوم المواطنة، أما حين تمتلك هذه القوى مصادر تمويلٍ مستقلة عبر اقتصادٍ مسلحٍ يقوم على التهريب واحتكار الموارد ونهب الثروات الطبيعية والتحكم في الممرات التجارية.. الخ فتلك كارثة كبرى.
في واقعنا المرير استند تكوين قوات الدعم السريع إلى بنية تعبئة قبلية، واتسعت قدراتها التسليحية والمالية عبر السيطرة المباشرة على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها مناجم الذهب في دارفور والممرات الحدودية. ومع اندلاع الحرب في أبريل 2023، اعتمدت تلك القوات استراتيجية السيطرة على المدن الكبرى والمنشآت الحيوية، مما أسفر عن موجاتٍ واسعة من الانتهاكات الموثقة. وقد ساهم هذا الدور في تفكك الدولة وتعميق الطابع الأهلي والجهوي للصراع، كما منح مبررًا إضافيًا لاستمرار الحرب كمنظومة مصالح مركّبة، لا كمعركة سياسية ذات أهداف وطنية واضحة أو مشروعة.
تعود جذور قوات الدعم السريع إلى بداية صراع دارفور مطلع الألفية، حين لجأ نظام البشير إلى تسليح مجموعات قبلية عُرفت بالجنجويد لمواجهة الحركات المسلحة خارج إطار الجيش النظامي. ومع الزمن، تحولت هذه المجموعات إلى قوة منظمة بإشراف مباشر من جهاز الأمن والمخابرات، واستُخدمت كأداة لحماية النظام عبر القوة المفرطة والانتهاكات الواسعة.
وفي عام 2013، أسس البشير رسميًا قوات الدعم السريع كقوة تتبع جهاز الأمن، قبل أن تُدمج شكليًا في الجيش عام 2017 مع احتفاظها بقيادة مستقلة وميزانية خاصة. وهكذا نشأت قوات الدعم السريع خارج بنية الدولة، كقوة موازية قائمة على أسس قبلية واقتصادية مرتبطة بمشروع التمكين وشبكات المصالح المحلية والإقليمية، لا كمؤسسة عسكرية وطنية مهنية.
ورغم التجربة الكارثية لهذا النموذج، لم يتعلم أصحاب القرار العسكري الدرس؛ فعوضًا عن تصحيح الخطأ التاريخي المتمثل في إنشاء قوة موازية خارج الدولة، أعادوا إنتاجه بصورة أوسع، فأنشأوا وموّلوا عشرات التشكيلات الموازية بعد اندلاع حرب 15 أبريل، ليصبح السلاح مشرعًا خارج القانون، وتتحول البلاد إلى ساحة مفتوحة للميليشيات المتنازعة ومصالح أمراء الحرب.
وعليه، فإن القول بأن “السلام لن يتحقق إلا بهزيمة الدعم السريع” هو تبسيطٌ مخِلّ لواقعٍ شديد التعقيد. فقوات الدعم السريع لم تعد مجرد تشكيلٍ ميداني يمكن سحقه عسكريًا، بل أصبحت شبكةً متشابكة من المصالح الاقتصادية والتحالفات القبلية والدعم الإقليمي. وحتى لو تمت هزيمتها ميدانيًا، فإن بنيتها الاقتصادية والاجتماعية قادرة على إعادة إنتاج نفسها بأشكال جديدة وأسماء مختلفة.
إن الرهان على “النصر العسكري الكامل” وهمٌ سياسي، لأن الحرب في جوهرها ليست معركة سلاحٍ فقط، بل معركة منظومات مصالح متشابكة محليًا وإقليمي ودولي. والمطلوب بالتالي استراتيجية مزدوجة تقوم على مسارين متزامنين:
الأول: تفكيك البنية الاقتصادية والتنظيمية والعدلية للدعم السريع بدلاً من الاكتفاء بالمواجهة العسكرية.
الثاني: بناء مؤسسات دولة قوية مهنية تفرض سيادتها على السلاح، وتُغلق الباب أمام إعادة إنتاج أي قوة موازية مستقبلًا.
السحق العسكري ليس وسيلة للسلام، بل السبيل هو نزع أسباب الوجود عبر تفكيك البنية التي سمحت للقوة الموازية بالنمو.
لمصلحة من تستمر الحرب؟
إن تراكم الثروات الهائلة لدى قيادات الجيش والدعم السريع والقوات المشتركة لم يعد مجرد ظاهرة اقتصادية معزولة، بل تحوّل إلى عاملٍ بنيوي في استدامة الحرب وتعقيد مسارات إنهائها. لقد أسهمت عمليات تعدين الذهب، وشبكات التجارة المحلية والإقليمية، واحتكار المنافذ الحدودية، والشركات المرتبطة بالأجهزة الأمنية، في إنشاء اقتصادٍ موازٍ يزدهر بالفوضى، ويستفيد من استمرار الانهيار الأمني والسياسي. وتحوّلت المؤسسات العسكرية إلى منظومات ربحية تُقايض الولاء بالعائد الاقتصادي، مما يخلق مقاومة تلقائية لكل محاولة لوقف الحرب أو تنفيذ مشروع إصلاح وطني يُهدد تلك الامتيازات. وعندما تصبح الحرب مصدرًا مضمونًا للثروة والنفوذ، تغدو استدامتها أكثر جاذبية من أي تسوية سياسية أو حلٍّ سلمي، وتتحوّل مصالح القوة إلى عائقٍ مركزي أمام تحقيق السلام.
إن الحقائق أعلاه تفرض إعادة بناء الأسئلة المطروحة في الساحة السياسية والأمنية، إذ لم يعد السؤال الحقيقي:
* ماذا نفعل بالجيش؟
بل “كيف نُعيد الجيش إلى الدولة؟” ليعود مؤسسةً وطنية مهنية خاضعة للدستور، لا ذراعًا سياسية فوق الدولة.
ولا ينبغي أن يكون السؤال:
* كيف نهزم الدعم السريع؟
بل “كيف نفكّك منطق تعدد الجيوش، ونمنع إعادة إنتاجه بأي صيغة مستقبلية؟
أما طريق السلام الحقيقي فلا يبدأ من ساحات القتال ولا من وهم “الحسم العسكري الكامل”، بل من إعادة بناء الدولة على أسس سليمة، ومن تحرير مؤسساتها من قبضة المصالح الضيقة، ومن تفكيك اقتصاد الحرب، واستعادة السيادة المدنية الكاملة على السلاح باعتباره حقًا حصريًا للدولة وحدها.